من يخاطب السيناريست؟
يقول الناقد الفرنسي الكبير إيريك دانييل بيير كانتونا: "كثرة الورش دليل على ضعف الكتابة"، ثم أتبع "واللي في القدْر يطلعه الملاس". بيد أن المسكين لم يستخدم المثل بالشكل السليم لأنه ليس من بيئته. على العموم، القدْر فاضي، وفائدة الملاس الوحيدة أن تستخدمه لتحك ظهرك، وكما نعرف لا يحك جلدك غير ظفرك، والحر تكفيه الإشارة.
قد أرتكب إثم الإضافة على كلام العلماء، وأزيد على كلام كانتونا وأقول لعل ورش الكتابة هي أحد الأسباب الرئيسة وراء تدني الأعمال الجديدة، هذه الورش التي حولت صناعة المنتج الثقافي إلى سلسلة من الخطوات والممارسة التقنية، والتي سرعان – في وسط يرعبه التفكير – تتحول إلى معتقدات سهلة التداول وخصبة ليتواطأ عليها الجميع.
عُرضت قبل فترة قريبة أول حلقتين من مسلسل “عايشين معانا” على منصة شاهد، وبعد توصية أحد الأصدقاء قررت أن أشاهد الحلقتين. فضلًا، تابع هذا المشهد القصير الذي لا يتجاوز السبعة والعشرين ثانية.
قرر السيناريست أن وجود هذا المشهد القصير مهم داخل العمل، وأنا لا أستخدم هذا المشهد إلا مثالًا، وإلا فإن الحلقتين الأولتين للعمل اللتان عرضتا حتى الآن ملأى بالمشاهد الصالحة للاستخدام كأمثلة بديلة. يحرضنا هذا المشهد على السؤال التالي: من يخاطب السيناريست هنا؟ أو وفق صياغة أخرى؛ من يخاطب السارد هنا؟ يقودنا هذا السؤال البسيط جدًّا إلى تتبع عناصر رئيسة في الكتابة والسرد عمومًا، فالمشكلة التي سأعرضها الآن تظهر أيضًا في الأعمال الروائية، ولعلي أبدأ بذلك فهو أسهل في الشرح والتتبع.
على الراغب في كتابة رواية أن يعي أنه يكتب حكاية تدور في مكان، وداخل هذا المكان شخصيات تريد أن تحقق شيئًا، وعناصر أخرى كثيرة، لنسمي هذا كله عالم الرواية أو فضائها. يسعى الروائي إلى بناء هذا العالم بما يسمح للشخصيات بالتحرك داخله، حيث تسير كل شخصية وفق دوافعها والأخطار التي تحدق بها. تسير هذه الشخصية بشكل عضوي مثل أي فرد في الحياة، تتجاذبه القوى المختلفة، مادية أو معنوية، وهو في خضم تحقيق ما يصبو إليه في حياته. وتخبو هذه القوى حول الشخصيات كلما ابتعدت عن المركز، مركز الحبكة والحكاية حيث البطل مركزها.
كنت سأضرب مثالًا ببريكن باد وقررت ألا أفعل ذلك لأنك تستطيع القيام بذلك بنفسك، وتجريب الأمر على أعمال متقنة أخرى.
إدراك الفضاء الروائي أو السينمائي خطوة محورية لأنها تساعد الراوي على اختيار من يحكي الحكاية ولمن، وعلاقته بالقصة وزمن سردها. الروائيون على دراية أكبر بهذا العنصر الرئيس من السينمائيين وكتّاب السيناريو، حيث يتكرر النقاش دائمًا حول الراوي العليم والمنظور الأول، لأننا دائمًا نسأل بوصفنا قراءً – وبشكل عضوي – عن المتحدث، كيف نعرف ولمَ يعرف كل هذه المعلومات وكيف، وهل هو موثوق وما إلى ذلك. فعندما تقرأ رواية وترى هامشًا يشرح فيه.. لا أعلم من الذي يشرح فيه، المؤلف أو الروائي، مفردة محلية أو مصطلحًا أو ظرفًا تاريخيًا، يجب أن تتساءل: من يخاطب هذا المؤلف أو الراوي هنا؟ من هو هذا المتحدث خارج المتن الروائي؟ وهو سؤال مشروع يربك الكثير من العناصر الرئيسة في العمل، بل قد يربك أيضًا العقد الضمني بين القارئ والعمل الروائي.
ومن المؤسف أن أقرأ أعمالًا روائية محلية، وخصوصًا تاريخية، يطل فيها صوت ما في الهامش ليتكلم ويعلق دون أن أعرف من هو هذا وما دوره. لبعض الروايات حيل فنية أحيانًا تندرج ضمن الشكل الروائي حيث تكون الهوامش للراوي نفسه، كأن يكون الراوي أو السارد طبيبًا نفسيًّا لإحدى شخصيات العمل ، ويعلق في الهامش من موقعه الروائي حول أمور مختلفة، وهذا لا يربك السرد لأن الهوامش ذاتها هي من ضمن المتن الروائي، وإنما أتحدث عن روايات ضمير المتكلم عندما تحوي هوامش.
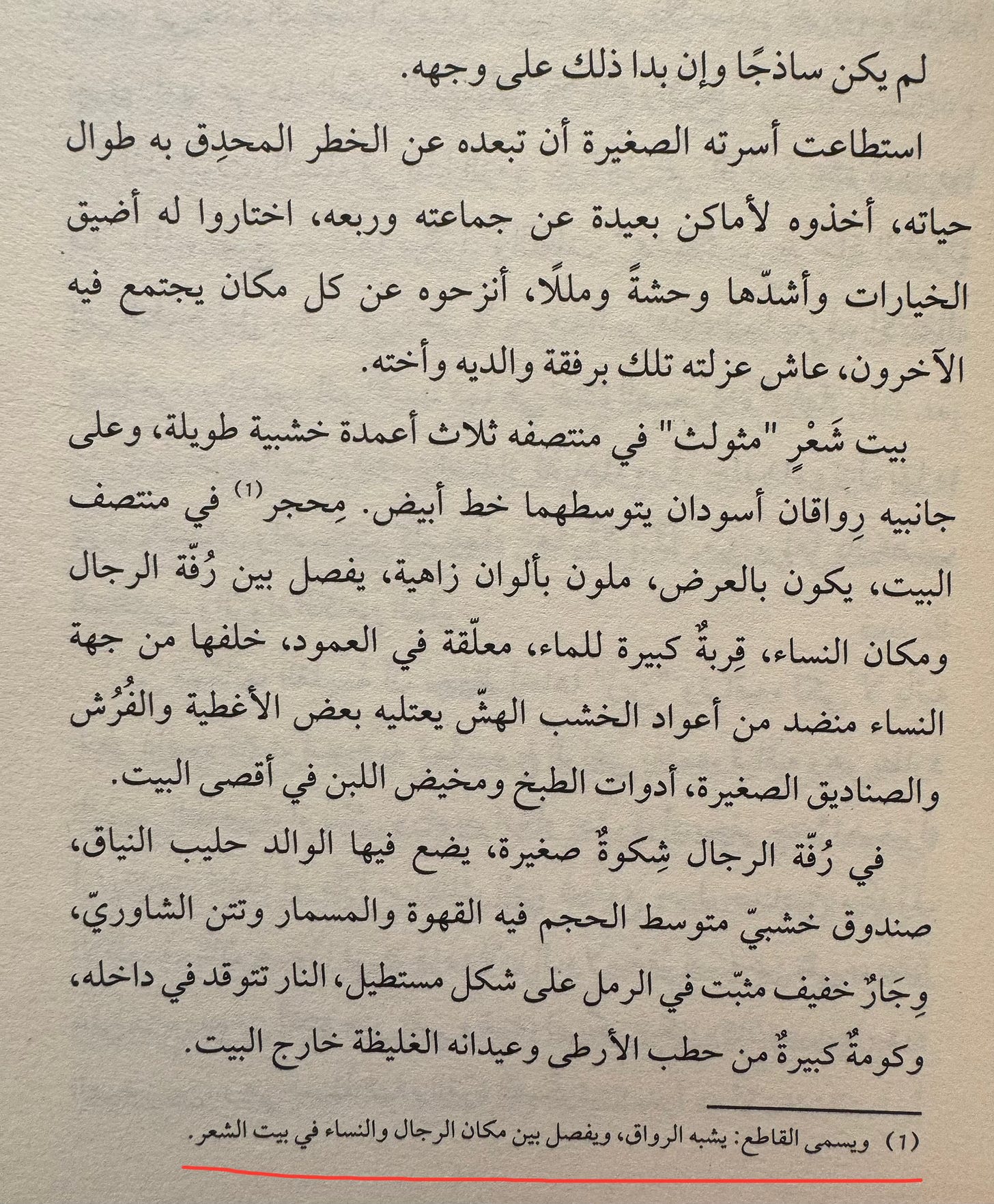
تظهر هذه المشكلة على نحو أكثر تعقيدًا في السينما والدراما عندما يغيب سؤال "من السارد؟" عن ذهن كاتب العمل، ولهذا الغياب عدة أسباب.
سؤال السارد يحيل بشكل إلى مباشر إلى المنظور، وفي الأعمال البصرية يتشابك هذا المصطلح مع مصطلح وجهة النظر POV أو Point Of View، هذا الأخير هو عندما يلتفت الممثل – مثلًا – ونرى في القطع التالي سيارة أو حديقة من حيث يقف الممثل، فنعلم أن هذا هو ما يراه الممثل، هو وجهة النظر من مكانه، هذه عينه، وهذا لا يتطابق تمامًا مع المنظور Perspective.
شاهد هذا المشهد الأيقوني من فيلم Mulholland Dr للمخرج ديڤيد لينتش (دبل توصية)، ولاحظ كيف تتبدل وجهة النظر بينها لدى دان (باتريك فيشلر) وبين وجهة النظر المحايدة (الكاميرا)، وكيف يستطيع المشاهد بشكل طبيعي فهم وتلقي السرد البصري المونتاجي هذا، ومن يعرف الفيلم وهذا المشهد، يعرف لماذا استخدم لينتش هذا الأسلوب، ولماذا هيأنا لوجهة نظر هذا الشخصية تمهيدًا للحظة الحاسمة في المشهد.
الجدير بالذكر أن أذهاننا المعتادة على فهم وتفسير المونتاج السينمائي بشكل لاإرادي وعفوي، لم تكن كذلك مع بواكير ظهور السينما. يذكر المخرج الإسباني الشهير لويس بونويل في مذكراته "أنفاسي الأخيرة" وجود وظيفة يقوم بها شخص يقف عند شاشة السينما Locutor ليشرح كل لقطة للمشاهدين، وقد يضيف أيضًا نكاتًا. وهذا الدور مشابه لما أصبحت تقوم به الشروح النصية Intertitles التي تظهر بين اللقطات. مثلًا، نرى ممثلًا يقوم من سريره ثم نرى كتابة على الشاشة (استيقظَ فتيخان من نومه فزعًا)، ثم نراه مثلًا يخرج من المنزل، ثم نرى كتابة (وقرر الذهاب إلى المطعم ليتناول إفطاره)، وانحسر دور هذه الشروحات مع مرور الزمن وتطورْ أدوات المونتاج والتمثيل واقتصرت على الحوار فقط إلى أن استبعدها بعض المخرجين حتى في فترة السينما الصامتة، وأصبح المشاهدين أقدر على فهم هذه اللغة البصرية، وردم الفجوات اللغوية فيها.
عودًا إلى موضوعنا.
قد نرى شخصيتين يجلسان بجوار بعضهما على الكنبة ويتكلمان، نرى كلًّا منهما في الإطار، أب وابنه، نرى الأب يتكلم بنبرة حادة، يقرّع، ويصرخ. نحن في تلك اللحظة لا نرى الـ POV للابن، فنحن نراهما معًا داخل الإطار، ولكن قد يكون ما نراه – وبحسب قرار صانع العمل – هي الصورة التي يرى فيها الابن والده، وربما لو كُتب العمل من منظور شخصية أخرى لرأينا الأب في صورة مختلفة، وذلك بحسب ما تراه تلك الشخصية في الأب، أي أننا نرى الأب من منظور الابن وإن لم نره من وجهة نظره POV.
في المجمل فإن غالب ما نشاهده هو من المنظور المحايد أو ما يسمى بمنظور الكاميرا، منظور المشاهد الخفي Invisible observer، وهو ما يوازي السارد العليم في الرواية، إلا أن هناك العديد من الأعمال التي توظف مناظير مختلفة لشخصيات مختلفة ومن أبرزها المسلسل الأمريكي Mr. Robot حيث أننا نرى ما يراه بطل العمل إيليوت، ولكن يتبدل المنظور باستمرار فيما يعكس إحدى أبرز موضوعات وثيمات العمل ذاته ألا وهو اضطراب إليوت نفسه والـ DID الذي يعاني منه.
ومن الأمثلة المحلية الجيدة حول النقطة ذاتها هو مسلسل وساوس من كتابة وإخراج هناء العمير، حيث نرى في كل حلقة منظورًا (وليس فقط وجهة نظر) مختلفًا لشخصية مختلفة، ويحدث أن نرى الموقف ذاته في حلقتين أو منظورين مختلفين، ونرى شخصية تظهر بشكل عدواني في الأول ولكن بشكل ودي في الثاني، وهنا يظهر كيف ترى الشخصية التي نرى الحلقة من منظورها الشخصيات الأخرى.
حين يعي السيناريست وصانع العمل موقع السارد والمنظور بعد أن يشيد عالمه ويضع فيه شخصياته التي ستتحرك الآن وفق القوى الفاعلة عليها، والتي إما ستقربها من هدفها أو تعرقلها، الآن نسأل: من يخاطب الكاتب في المشهد السابق للممثلة عائشة كاي في مسلسل “عايشين معانا”؟
الإجابة واضحة: يخاطبنا نحن المشاهدين، وتلك هي المشكلة. هذا الفعل هو ذاته عندما يضع المؤلف أو الراوي هوامشًا يشرح فيها بعض المصطلحات أو السياق، ولا يدع شخصياته تتحرك في عالمها وفق خططها ودوافعها، وأننا لسنا مجرد متابعين خفيين نتطفل على ذلك العالم. في ذات المشهد، لا تقوم كلتا الشخصيتين بأي فعل يخدم المسار الدرامي لهما أو لوجودهما داخل العمل (إن وجد)، وإنما لتعطينا معلومات، وهذا يختلف تمامًا عن الأعمال المشهورة التي نشاهد، اختر أيًّا منها وبشكل عشوائي ستجد أن الشخصيات في أي مشهد تتحرك وفق ما يخدم مصالحها وأهدافها دون أن يخاطب مشاهد مفترض أو يحتاط لوجود مراقب له أو "يشيل هم" ألا يفهمه أحد.
يُستثنى من ذلك تلك الأعمال التي تكسر الجدار الرابع، وهذا غير ممكن أصلًا إلا عندما نعي المنظور جيدًا ودوره، ولذلك تكون تقنية كسر الجدار ناجعة عند المدرك تمامًا للمفاهيم التي ذكرنا كما في – مجددًا – مستر روبوت (واضح توي مخلصه). ففي المسلسل نرى التكامل بين الشكل السينمائي (البويتيقا.. عشان تقولوا فاهم) وبين موضوع العمل.
في الحلقتين الأولى والثانية من مسلسل "عايشين معانا" واللتان يشكلان مجتمعتين ٨٤ دقيقة، رأينا جل ذلك الوقت في مخاطبتنا نحن المشاهدين؛ يسدد الولد الكرة فتخرق السياج الشبكي، الأولاد يعبرون الجدران، العملة المعدنية المعلقة في الهواء، إيقاف زوارة الجيران إلخ إلخ.. كل هذا لكي تخبرنا أنهم جن؟! ليس هناك خلل في فهم المنظور وموقع السارد وحسب بل هناك إسراف كبير في هذه العلة السردية!
يحيلنا هذا بشكل ضروري إلى الفكرة الرائجة، معشوقة جماهير ورش كتابة الرواية: Show Don’t Tell، أرني ولا تخبرني، والتي حُلبت حتى استُنفد معناها. بات البعض يظن أن الأسلوب السردي السليم هو في تحويل الحوار إلى صورة، وبذلك يكون قد "أرانا" دون أن "يخبرنا"، في حين أن الفكرة أبسط ولكن ليس بتلك المباشرة الساذجة، فنحن عندما "رأينا" العملة المعدنية المعلقة، والتسديدة الخارقة لم يكن ذلك إلا "إخبارًا" مباشرًا بماهية هذه الشخصيات، وكان الأجدى أن يجعل هذه الشخصيات تسير وفق أهدافها الدرامية داخل العالم الدرامي ونحن المشاهدين نرى ونفهم هذه الشخصيات دون إخبار.
والعكس، قد يكون أحيانًا الحوار "رؤية" وليس "إخبارًا" وهذا هو المعتاد أصلًا في الحوارات الدرامية والسينمائية، لا تقول أي شخصية ما تريد بشكل مباشر، والحديث بينهما دائمًا ما يحيل إلى مناطق أخرى، وبالتالي فإن الحوار السينمائي الجيد هو الذي لا يخبر.
من المؤسف – والغريب – أيضًا وفرة ورش الكتابة التي تقتصر على التقنيات فقط ووجود مثل هذه الأعمال، ولا أظن أن مسلسل "عايشين معانا" استثناء، بل أستطيع الجزم بأريحية بأن الخطأ ذاته متكرر كثيرًا. ولا أستغرب أيضًا أن مقدمي تلك الورش ودورات الكتابة هم ذاتهم كتّاب هذه الأعمال الرديئة.




https://x.com/baileymeyers/status/1956564233543672159