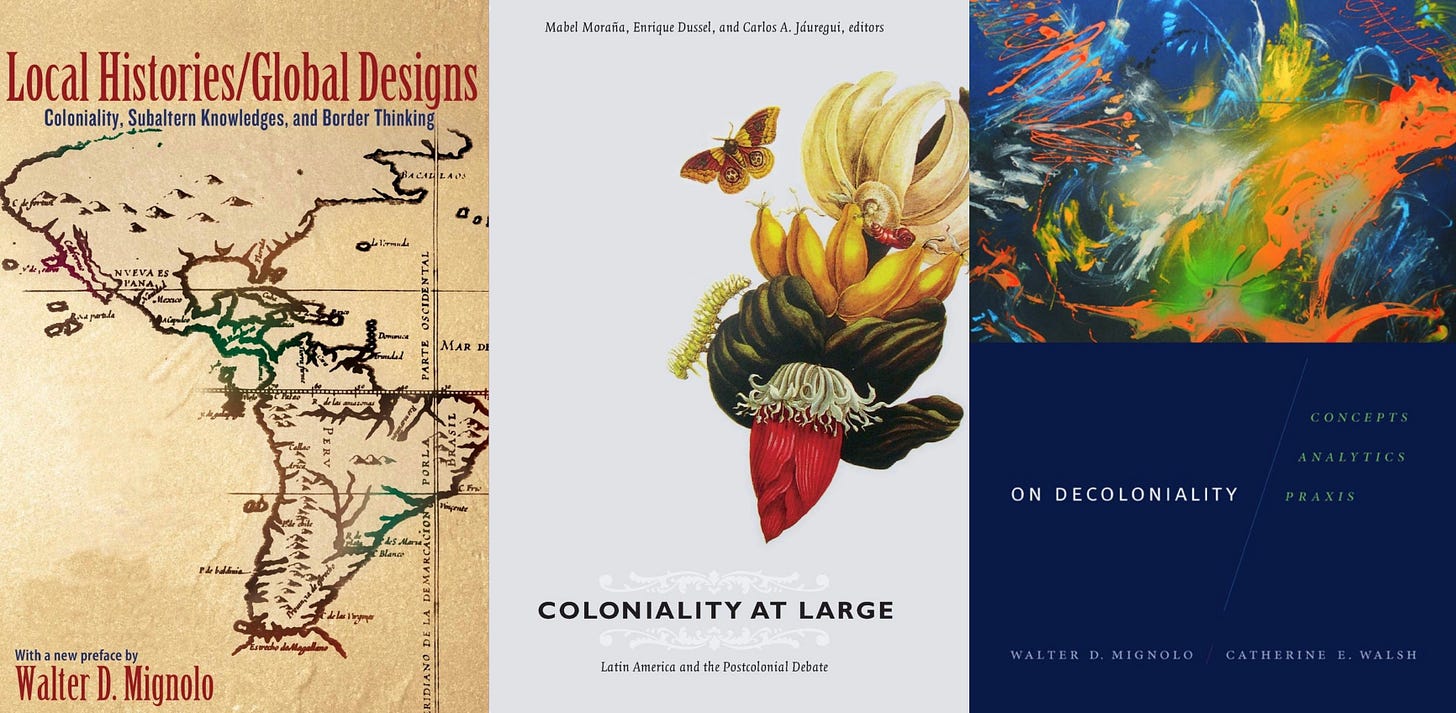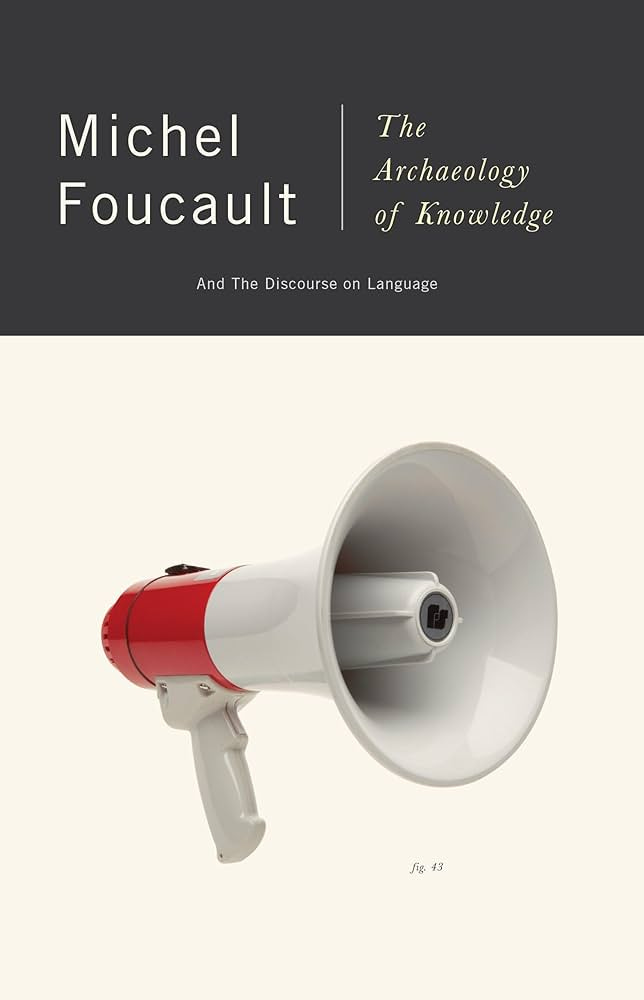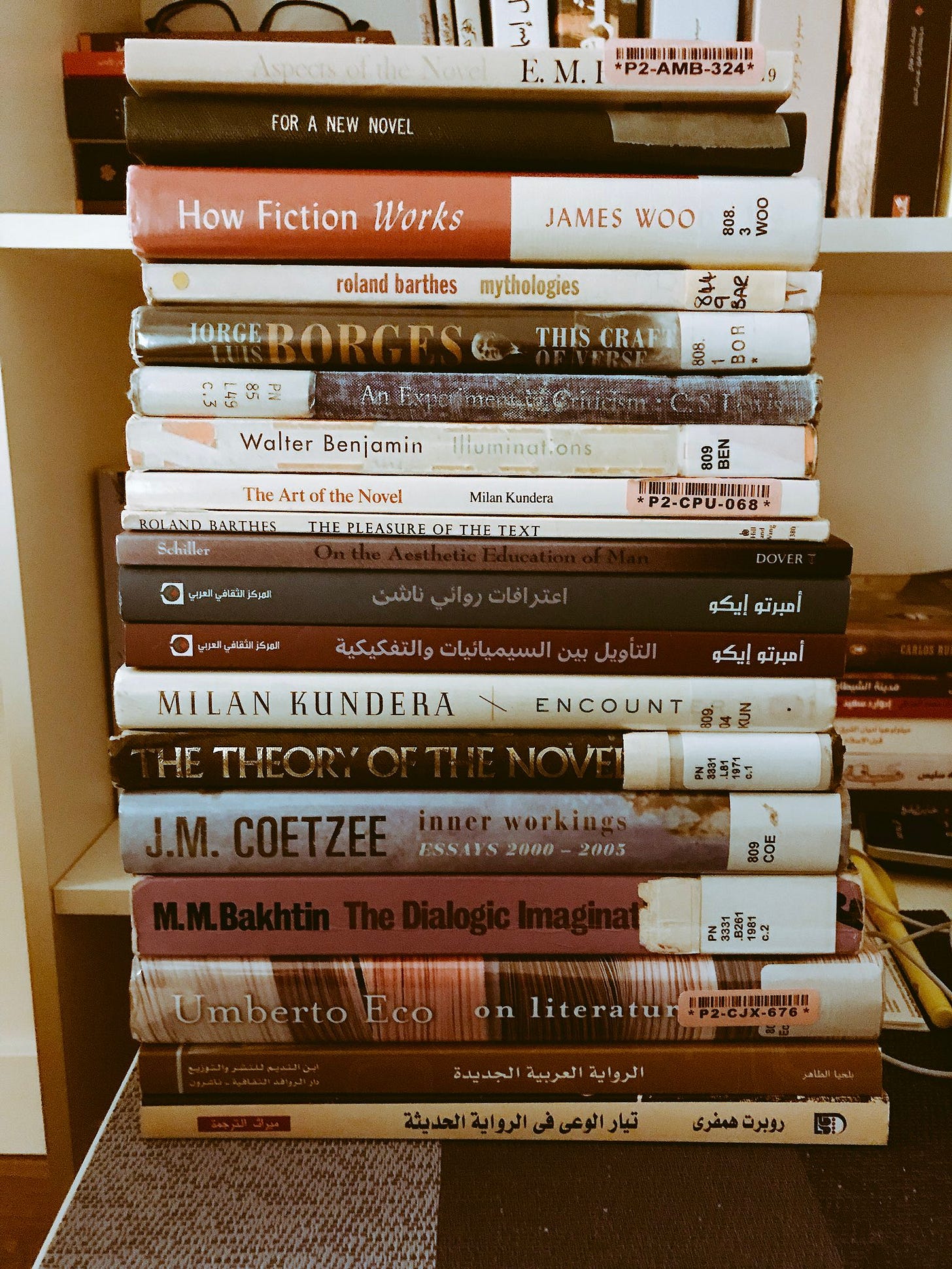مخرجون شكلوا حسي الفني: ما يشبه المقدمة
"ذبحتنا بسالفة المحلية وعدم إمكانية تلقي الأعمال العالمية وآخر شي مسوي سلسلة عن أعمال غير عربية وغير سعودية؟"
سؤال جيد جدًّا، وهذا "استقعادٌ" محمود. تلقي أعمال من ثقافات أخرى ممكن بكل تأكيد ومتاح للجميع، ولم أقل بتاتًا أنه ليس كذلك، ولكن تلقيها تمامًا كما يتلقاها الجمهور المحلي لأنها أعمال "عالمية" تقدم قيمًا عالمية وموضوعات عالمية و"إنسانية"، فذلك ما أختلف معه.
يستطيع كل مشاهد أن يتلقى أي عمل من خلال ما يحوي من قيم موجودة في كل المجتمعات البشرية، لدى التجربة الإنسانية في كل مكان مفهوم للحب والحزن والفقد والحسد والأمومة والإحسان إلخ. هذه القيم أصيلة في كل قصة، ويصعب انتزاعها من أي حكاية، بل أن الفنون السردية والبصرية ترتكز على هذه القيم لتجعل منها ثيمات يدور موضوع الفيلم وعناصرها في فلكها، ولكن الزعم بأن تلقيك هو تلقي الجمهور المحلي وبأنك قادر على قراءة وتحليل ونقد أي فيلم من كل ثقافة وأن تكون مرجعًا في ذلك لأنك تحمل شهادة ما أو تتقن استخدام منهج نقدي ما، فنعم.. تلك خرافة "چايدة".
ليس من الصعب أن يعي القارئ أن لدي مشكلة مع مفهوم "الكونية"، كونية القيم والأفكار والثقافة، ولذلك قد يعي أيضًا نفوري مما قد يندرج ضمن السرديات الكبرى، أو لأقل تعميمها وليس هي في ذاتها، ولذلك من الطبيعي أن تكون كتاباتي ذاتية، وذلك لا يعني أنها محض آراء لحظية مطاطة، وإنما أقصد أني أنطلق مما هو ذاتي وخاص في مسألة التشخيص والتحليل ومن ثم قياس ما يمكن سحبه من ذلك إلى العام.
وهذا ما يتوازى تمامًا مع اهتمامي بموضوعات "الديكولونيالية" وتحديدًا ما يخص استعمارية المعرفة، ونقد كل من يقدم سردياته الكبرى على أنها الوحيدة ولا يقبل بمشاركة سرديات أخرى من ثقافات أخرى بذرائع مختلفة منها خرافة التقدم والتأخر أو الأخلاقي واللاأخلاقي.
يندر أن أستشهد بأسماء وكتّاب لأني أعتقد أن هناك من يكثر من الإحالات والاقتباسات لا لشيء إلا للهياط المعرفي، وهو في غنى عن تلك الاقتباسات، إلا أني سأسمح لنفسي لأني أعتقد أن هذه المصادر عظيمة، فتلطّفوا عليّ بحلمكم، or dont، مش فارقة معاي.
فيما يخص كونية القيم واستعمارية المعرفة فإن التأثير الأكبر علي كان من الباحث الأرجنتيني والتر منيولو وكتابه “Local Histories / Global Designs” وكذلك مجموعة أخرى من الديكولونياليين مثل دوسيل وكيخانو وغيرهم الذين تطرقنا لهم في حلقة “العصيان المعرفي” في بودكاست كتبيولوجي هنا.
وإذا ما أضفنا ميشيل فوكو وتحليل الخطاب وديناميات القوة وارتباط المعرفة بالسلطة، تكون الخلطة الفكرية لدي شبه مكتملة في قراءة وتحليل ما أتلقى من نصوص وأعمال فنية، وبالتأكيد يضاف إليها كل ما أملك من تراكم معرفي في النقد الأدبي والثقافي والسردية الكلاسيكية في المدونات النقدية وثالوث المعنى والشكل والموضوع وغيرها، وكذلك التراكم المعرفي من حقول معرفية أخرى وتجارب حياتية.
قد لا ترى هذا الذي ذكرت في المقالات القادمة بشكل مباشر، وإنما هذه المنهجية هي ما تضبط الذهنية النقدية لدي mindset، وهي ما أنطلق منها في تلقي العمل الفني، أما ما أستنطقه في الفيلم فهو عائد إلى خليط من الحصيلة المعرفية وأيضًا معرفتي بتقنيات السينما في التكوين البصري والسينماتوغرافي وتعاضد المؤثرات السمعية والبصرية في السرد السينمائي، واتفاق هذا الأخير مع موضوع الفيلم.
في مشروع ثقافي سابق أنشأته مع الصديق حسين إسماعيل، أسميناه منصة رؤى، وهي منصة ثقافية لنشر المقالات، أفردنا قسمًا في المنصة وأسميناه "مجهريات"، وهو يقوم على السرديات الصغرى والانطلاق من الذاتي إلى العام، واعتمدنا بحسب ما أتذكر مفردة "التذاوت" لترجمة كلمة intersubjective لوصف تلك الحالة التزامنية المستمرة بين ما نتلقى وبين الموضوع أو المادة أو النص، وأن عملية الاستنطاق التي نقوم بها لأي نص وما ينتج عنها لا تعبر بشكل كامل عن الذات ولا عن النص نفسه وإنما في منطقة بين الاثنين.
نشرنا العديد من المقالات الممتازة تحت "المجهريات"، منها مقالة حول كيف غيرت قيادة السيارة لإحدى النساء علاقتها بالشارع، وعلاقتها بالفضاء العام الذي كان يقمعها سلفًا، وأيضًا مقالة حول علاقة الفرد السعودي بسيارته بوصفها ليست فقط وسيلة للتنقل وإنما فضاء ثقافي متكامل يتجاوز حتى حضورها كصورة للحالة الاجتماعية لصاحبها. وأيضًا مقالات أخرى لأفراد تحكي حكايتهم الخاصة ومن ثم ينطلقون إلى ما هو عام.
هنا عبر المقالات الثلاثة القادمة، سأتحدث حول أكثر ثلاثة مخرجين ساهموا في تشكيل حسي الفني. لن تكون مراجعات لأفلامهم وإن كان هناك ذكر لبعض المشاهد منها، وإنما قراءة تقع بيني أنا وبين أعمالهم، مقالات تذاوتية تجمع ما قد يكون سيَري وما هو أدبي وما يخص المخرج والفيلم نفسه. قراءات قد تحكي عني أكثر مما تحكي عنهم، ربما، ولكنها بكل تأكيد كاشفة لأساليب فنية رأيتها أنا من حيث أقف – أو لأقل أجلس – وأسباب ارتباطي بها وتقاطعي معها على المستوى الموضوعاتي والفني. هي قراءاتي التي قد تشبه وقد لا تشبه كل ما هو موجود في أي مدونة نقدية رسمية أو غير رسمية، ولكنها متسقة ومعتبرة.
بعد انتهائي من كتابة المقالات الثلاثة وجدتني أفهم نفسي واهتماماتي وما يثير انتباهي بشكل أفضل، ولعلني توصلت إلى ما ما تتجذر فيه هذا الاهتمامات الموضوعاتية وكذلك تعرفت على ذائقتي فيما يخص الشكل الفني بشكل أدق، وهذه من أفضل فوائد تلقي الأعمال بشكل ذاتي ومساءلة انطباعاتنا لنرى إن كان ثمة اتساق فيما نحب أو نكره، ومن ثم نستطيع أن ننقد الأعمال ليس بوصفنا كائنات لاتاريخية متسامية على الظرف الزماني والمكاني والثقافي وجميع انحيازاتها، وندعي أن تلقينا موضوعي لأننا نستخدم المنهج الأكاديمي هذا أو ذاك، وإنما من خلال الأخذ بالاعتبار لهذه الانحيازات الطبيعية، وتطبيع حضورها في مشهدنا النقدي لنحسّن من مستوى التواصل المعرفي بيننا، وهي الأخرى من أبرز المشاكل الثقافية والنقدية عندنا.
المخرجين الثلاثة هم: البولندي كريستوف كيسلوفيسكي والسويدي إنغمار بيرغمان والإيراني عباس كيارستمي. لا أعلم إن كنت سأمطُّ هذه السلسلة وأتطرق لاحقًا لمخرجين آخرين تأثرت بهم، ولكن لأبدأ بهولاء الثلاثة ومن ثم نرى.