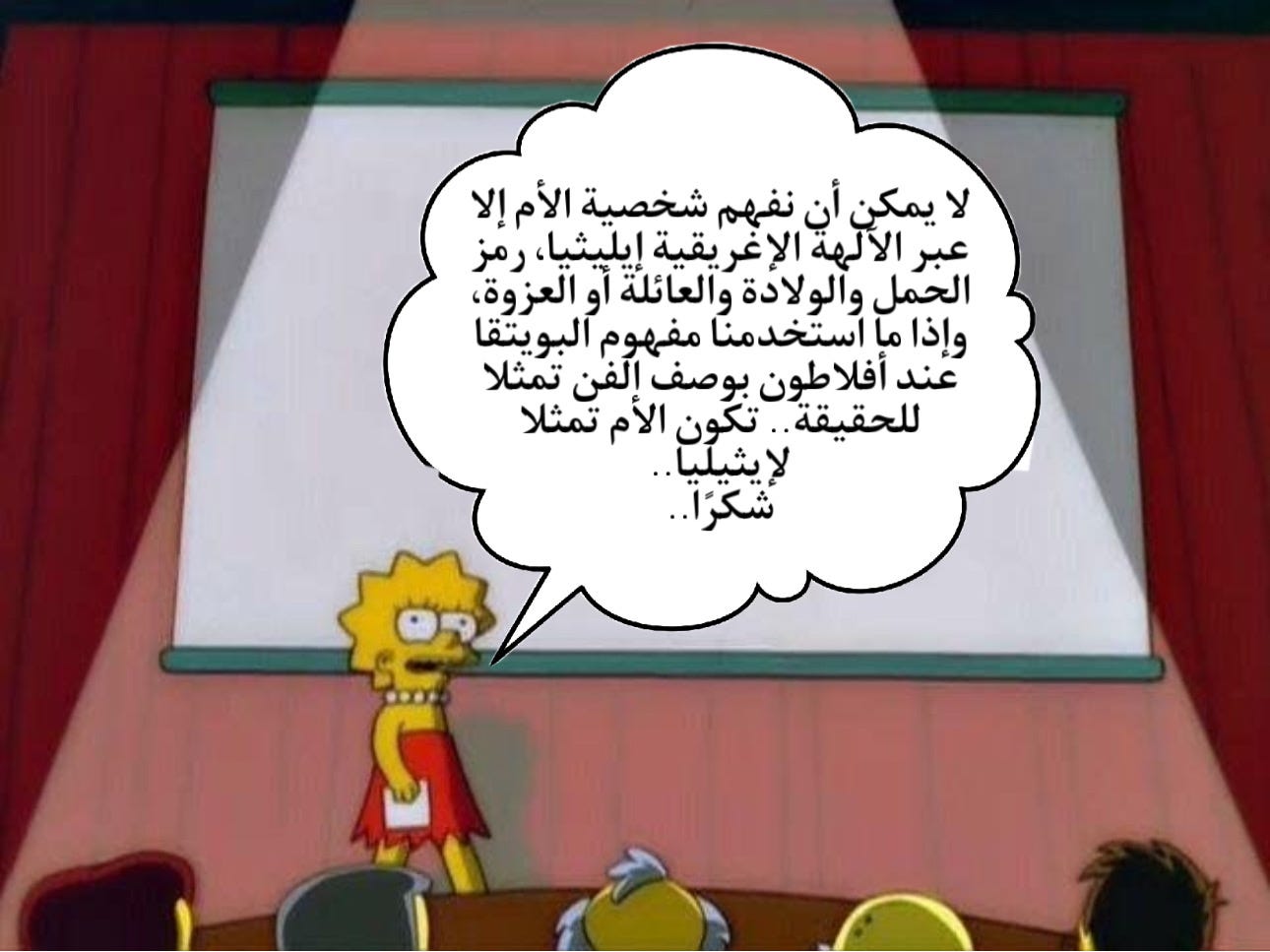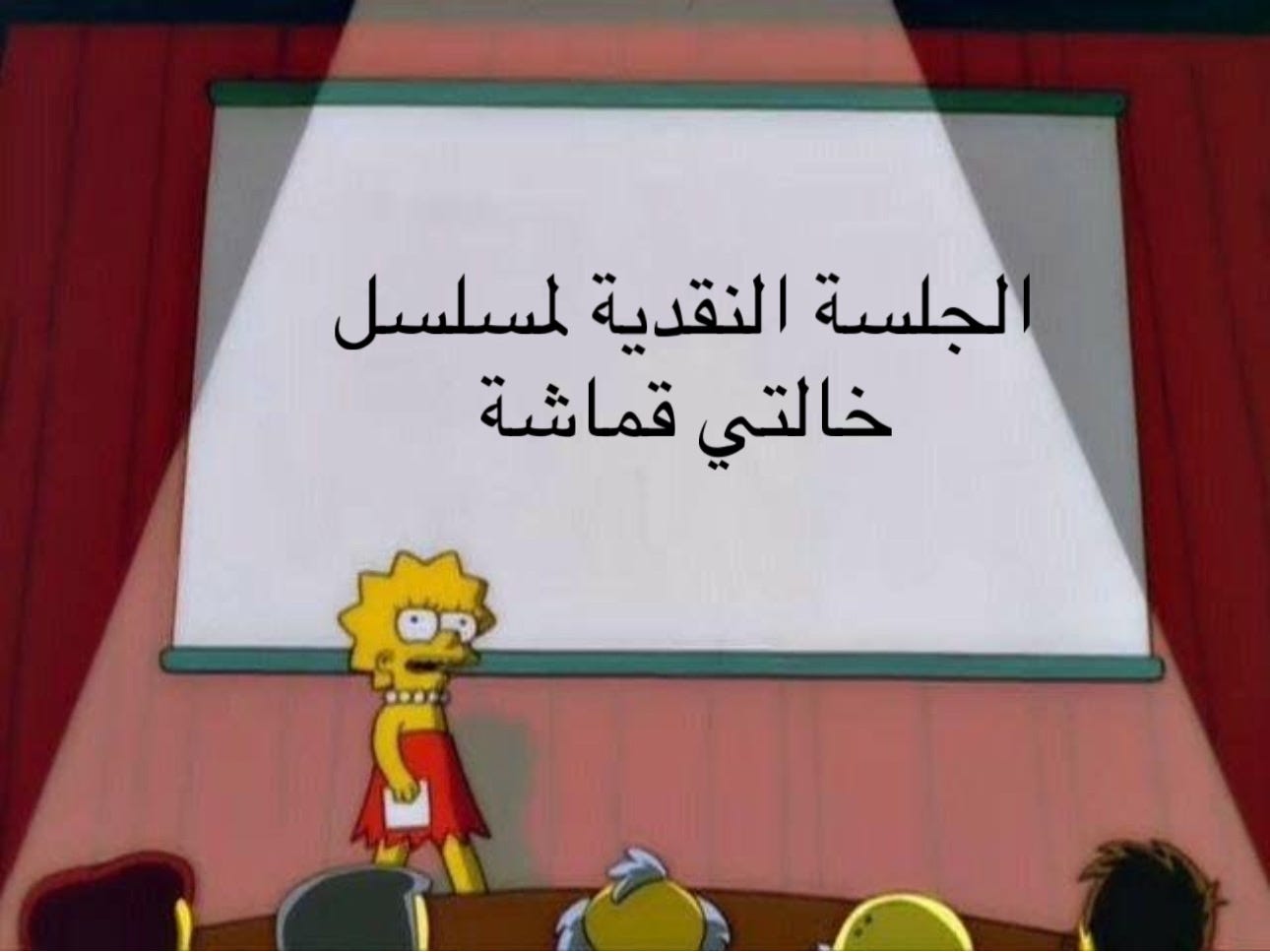وهم المقاربات اللامعرفية في الوسط السينمائي
كتبت على إكس ثريد حلطومي - كما هي العادة - حيال الأفكار المتداولة في المشهد السينمائي السعودي، مرّرت في ذاك الثريد تذمري على شكل سؤال افتراضي، ماذا لو، ماذا لو قررنا أن نتناول موضوعاتنا السينمائية بشكل منعزل تمامًا عن كل ما نعرفه ونسمع عنه في الأوساط السينمائية الأخرى في العالم، ليس لغرض القطيعة والعزلة الثقافية، وإنما لتعزيز إنتاج المعرفة بالطريقة الأصيلة المستندة على ما نملك من معطيات وبيانات. رغبت من هذا الاقتراح أن أشير إلى سلوك متفشي ليس فقط في الطرح السينمائي الذي أراه في اللقاءات المختلفة مع الممثلين والمخرجين والكتّاب وغيرهم في المجال، بل هو رائج أيضًا في مختلف المجالات الثقافية وغير الثقافية الأخرى. هذا السلوك المعرفي العقيم هو إنتاج المعرفة – أو اللامعرفة – عبر المقاربة Analogy.
لنتخيل هذا المثال.
لنقل أنك أحد المسؤولين في الطاقم الفني لأحد الأندية الرياضية لدينا، نادٍ يجلب السعادة، تمامًا مثل رؤية هلال العيد. أُوكلت إليك مهمة دراسة الحالة الفنية لأحد مدافعين الفريق، ممن تدنى مستواهم بشكل ملحوظ مؤخرًا، وأصبحتْ صافرات الاستهجان تأتيه من كل صوب، ومن جماهير النادي ذاته. لنقل أنك عوض الرجوع إلى بيانات اللاعب البدنية والفنية، وما تتيحه التكنولوجيا اليوم من تعقب لتحركاته ودراسة كل ما يخص سلوكه الفني والنفسي وما إلى ذلك، واستنباط نتيجة شاملة ومدعمة بالبيانات الملموسة Hard Data، تقرر أن تمضي في منحى آخر تمامًا.
تقرر أن تجد لاعبًا في الدوري الأمريكي تطابق صفاته صفات اللاعب لديك، الجسدية والنفسية، ويحمل ذات السلوك النرجسي، وحب الأضواء، وذات البنية الجسدية، ويلعب في ذات المركز، وبجواره لاعبين مشابهين لمن يلعب بجوارهم لاعبك، ويلعب في نادي يحمل ذات السمات لناديك، وغيرها من التفاصيل الكثيرة. تواصل بحثك بجد وإصرار، لا لشيء سوى أن تجد هذا اللاعب المنشود الذي يطابق لاعبك، ومن ثم تبحث عن محلل وناقد رياضي أمريكي سبق أن درس حالة ذاك اللاعب وقدم قراءته عليه، لكي تستخدم أنت ذات القراءة على لاعبك.
صياغة المثال بهذا الشكل يظهر العبث – وربما العبط – المعرفي الذي يمارَس في كثير من المنتجات الثقافية والنقدية المطروحة في مشهدنا السينمائي. منهج المقاربات أسلوب سائد في إنتاجنا المعرفي، وهو إنتاج لا معرفي وبلا قيمة. من المحزن أن أرى وأسمع يقين المتحدث بهذا المنهج المقارباتي، وهو يقين مبني على وهم، هناك صورة متخيلة في ذهنه بأن العالم، شرقه وغربه، يقوم بذات الاشتغال المقارباتي في سبيل إنتاج المعرفة، ويفوته غياب هذا الأسلوب في العالم – وهو أمر لا يعد حجة في ذاته – ولكنه مؤشر لعدم أهلية هذا المنهج في إنتاج المعرفة أساسًا.
تجاهد الحقول المعرفية المختلفة في أن تكون مقودة بالمعطيات الملموسة والبيانات المرصودة كي تقلل من فوضى الحدس والتأملات، ولذلك البيانات المقاسة مباشرة ذات قيمة عليا في الإنتاج المعرفي، لأنها قيم حقيقية موضوعية وليست ذاتية أو محض آراء، وتبنى عليها القراءات والتحليلات. إرساء هذا النهج المعرفي، هو الأساس، وهو الذي يجعل المقاربات – إن وجدت – مجرد إضافات ثانوية، تُفهم في سياق وإطار ما أنتجنا نحن بشكل أصيل من خلال معطياتنا، لا أن تكون الأساس ونحن بكل ما نحمل من ثقافة ومعطيات وأرقام وطرق تلقي وتاريخ إلخ.. ندور في فلك تلك المقاربات المعقودة على عواهنها.
تنتِج هذه المقاربات المسلوقة سلقًا، بجانب غياب القراءة والاطلاع أساسًا، مجموعة أقوال تتحول بعد ذلك إلى ما يشبه الوصايا، شيء أشبه بالمرويات الدينية، صحاح السينما، وعليه لا أحد يراجع هذه الأقوال والتي هي في الأساس ليست سوى تأملات وحدس. التفكير الحدسي والباحث الرصين شيئان لا يجتمعان، خاصة وأن كثير من أمور الحياة مخالفة للحدس، ولكن تتكرس هذه الأقوال لتصبح شيء متفق عليه ويجب الالتزام به، في حين أنه هو ما يحمل لب فشلك، ولا يتوافق بتاتًا وحالتك المعرفية واحتياجاتها.
“نحتاج إلى سينما تجارية جاذبة، وأفلام تتصدر شباك التذاكر كي يثق المنتج والمستثمر في الفيلم السعودي وتتعدد مصادر التمويل له ومنه يبدأ الإنتاج السينمائي السعودي في الازدياد، وتتكون قاعدة جماهيرية.. إلخ"
هذه إحدى الأفكار الرائجة في اللقاءات السينمائية، وهي كثيرة جدًّا، وكم أرغب أن أفرد مقالات منفردة لكل منها كي نراجعها ونناقشها وفق معطياتنا؛ "هناك أزمة نص"، "تجنَّب السرد اللاخطي!"، "إياك ثم إياك أن تضع صوت للسارد"، "استخدم اللهجة البيضاء"، "السينما فن عالمي.. اجنح إلى التجريد الثقافي"، "شو دونت تيل"، "هذي أفلام مهرجانات (طبعًا لسه لم أقبض فعليًا على المعنى الفعلي لهذا الوصف)"، "نحتاج للنقد كي نتطور"، "تدري إن في حاجة اسمها سكربت دكتور؟"… المهم عندي لستة طويلة جدًّا، وإذا كتب الله، سأتناول معظمها في مقالات قادمة.
عودًا إلى فكرة احتياجنا للسينما التجارية، لا أقول إنها خاطئة، لكن لم أقع على أي طرح يراجع هذه الفكرة، هي فكرة مقتبسة من نموذج ثقافي آخر، ولا نعلم إن كان النموذج ذاته موجود في أسواق سينمائية أخرى في العالم، وهذا النموذج السينمائي ينتمي إلى ثقافة عالمية مهيمنة ولها أدوات وإمكانات ودوافع وآليات مختلفة تمامًا عما نملك. مشكلة هذه الأفكار أنها مصاغة بشكل رصين، وتلامس التفكير الحدسي للمتلقي فيتقبلها بسرعة، فكرة تجمع بين الرصانة الإنشائية والقبول الحدسي، وهو ما يجعلها تمر عبر رؤوسنا دون مناقشة أو تحدي لها.
لكن لو سلمنا بصحة هذا المقولة، وأردنا أن ننتج أفلامًا سينمائية تحطم أرقام شباك التذاكر، ما هي الخطوة التالية؟ بحسب ما ذكرت سلفًا، ينبغي أن نعود إلى ما نملك من معطيات، أن نعود إلى ما أنتجنا خلال السنوات الماضية. كم فيلمًا سعوديًا أنتجنا خلال العشرين سنة الماضية؟ خمسون فيلم؟ مئة؟ أو أقل من ذلك بكثير لكنه بلا شك كاف لننطلق منه كي نفهم من خلال هذا المنتج السابق جمهورنا الذي نستهدف. إلا أن لفريق المقاربات رأي آخر، يريد أن يرى ما هو رائج في هوليوود، ويقضي وقته في دراسة كتاب "إنقاذ القطة" لبليك سنايدر وهو المبني على سوق سينمائي مختلف تمامًا، ويشغل الجميع ويبذر الموارد في دراسة ما قد لا يتوافق مع متطلباته ومتطلبات جمهوره. إذا كانت معطياتك تخبرك أن جمهورك أحب هوبال وخيوط المعازيب وشباب البومب وجاك العلم، فما الذي يمكن أن نستنتجه من هذه المعطيات ويخدم فهمنا للجمهور كي نستطيع توظيفه في أفلامنا القادمة لاستقطاب الجمهور؟ هل يبحث الجمهور السعودي عن أفلام تحمل الطابع التوثيقي للثقافة فيما يخص الأزياء واللهجة وطرق التعبير المحلية كما رأينا في هوبال وخيوط المعازيب وجاك العلم؟ ماذا عن فيلم هجان، لمَ لم يلق الرواج ذاته إذًا؟
نبذ المقاربات بوصفها وسيلة للإنتاج المعرفي يؤدي إلى طرح الأسئلة الأصيلة، هذه هي أسئلتنا التي يجب على الباحثين والمهتمين طرحها ومناقشتها، وهي أسئلة لن تجدها عند تارانتينو ولا كيارستامي ولا بيرغمان أو كوراساوا، ومن باب أولى لن تجد أجوبتها عندهم أيضًا، لأنهم غير معنيين بها. الاشتغال المعرفي هو اشتغال عضوي في الأساس، أي أنه نابع عن حالة صادقة وأصيلة وموجودة على الأرض، تتطلب إجابة لغرض منفعة ملموسة. الاشتغال المعرفي ليست مجموعة وصايا ومدونات سردية تحمل تاريخ أفكار سينمائية لثقافة ما نكررها في ندواتنا فقط لغرض رفع الكلفة البحثية، أي فقط لنقول أن لدينا كتابات نقدية وبحثية، وبعدها نقوم ونعمل بحسب أهوائنا. لذلك لا أستطيع لوم المشتغلين في الحقل السينمائي حين يتجاهلون مخرجات تلك الكتابات، فهي في الحقيقة مفتعلة وبلا قيمة.
هناك طرح آخر أراه أيضًا مضللًا، وهو الطرح الذي يقدم نفسه بوصفه تقعيدًا فلسفيًا في حقل الجماليات والاستطيقا، ويريد أن يكون قاعدة ننطلق منها في تلقينا للأفلام والفن عمومًا. أتذكر مقالة للكاتب يزيد السنيد على منصة ميم حول جماهيرية الفن. مشكلة هذه الكتابات – بجانب كونية وعالمية الفكرة – هو اعتقاد أن هناك خط تاريخي متصل للأفكار، يبدأ في نقطة محددة ويمتد إلى اليوم، أي أن هناك فهم وتلقي استطيقي يمتد من مسرحية "أوديب ملكا" إلى "درب الزلق"، وبالتالي عملية إنتاج المعرفة عندهم دائمًا تبدأ بالعودة إلى نقطة معرفية وتاريخية محددة، نقطة الاكتمال المعرفي. هذا دون التطرق حتى إلى تلك النقطة والتي هي في الأصل محل إشكال، ولكن الحديث حول الموضوع قد يطول ويأخذني إلى موضوعات لا تعني موضوع المقالة هذه، سأتركها لوقت آخر.
علينا أيضًا أن نكون ناضجين حيال النتائج المعرفية الأصيلة التي نتوصل إليها إذا ما استندنا إلى معطياتنا، قد لا تروق لنا النتيجة ولكن يجب أن نتقبلها، ربما نصل إلى نتيجة أن الجمهور لا يريد سوى أن يرى أناس تتكلم مثلنا وتلبس مثلنا دون أي اهتمام للسيناريو أو الحبكة أو الرحلة الذاتية للشخصية وغيره مما يُدرس في ورش الكتابة، وهذا مما يغيظ أصحاب الفحولة السينمائية (في العادة هم من يشيرون إلى أنفسهم بـ cinephile وmovie buff) لأنهم يريدون للجمهور أن يكونوا محنكين مثلهم، ويُحبطهم أن يجدوا جمهورًا عاديًا يريد فقط أن يستمتع بالأفلام البسيطة، وعليه يصبح هؤلاء دخلاء على الفن السينمائي الأصيل والتلقي النبيل وحساسية الذوق الجليل.. في مدينة النخيل كل شيءٍ جميل..
المفارقة التي لم يستطيعوا أن يجدوا لها حلًّا هؤلاء الفحول هي احتياجهم لهذا الجمهور الذي يحتقره، لذلك نراهم يتغنون بالوصايا والمقولات التي أنتجتها المقاربات اللامعرفية البائسة وفي الوقت ذاته يفاخرون بهذا الجمهور وحضوره، وينشرون إشادته بأفلامهم وهم الذين يحتقرونهم ويحتقرون آراؤهم، وهذا جلي في فيلمي شباب البومب وهوبال، فهما اللذان نجحا في استقطاب جمهور جديد غير المعتاد، وأدخله إلى السينما للمرة الأولى. بالنسبة لي هذا مدعاة للفخر، ولي حديث حول هذا النوع من التلقي الذي يحتقره هؤلاء المحنكين، وسأدعه للمقالة القادمة حول التلقي السينمائي في السعودية.
ختامًا، أذكر بالفكرة الرئيسة لهذه المقالة المتمثلة في الإنتاج المعرفي الأصيل النابع عن البيانات والمعطيات المباشرة، وأن القفز المقارباتي – والمدعّم بخرافة عالمية الفن – لا علاقة له بتاتًا برصانة النتائج المعرفية، بل يخلق حالة من الوهم والتضليل المعرفيين، وهو وسيلة مضمونة للفشل.