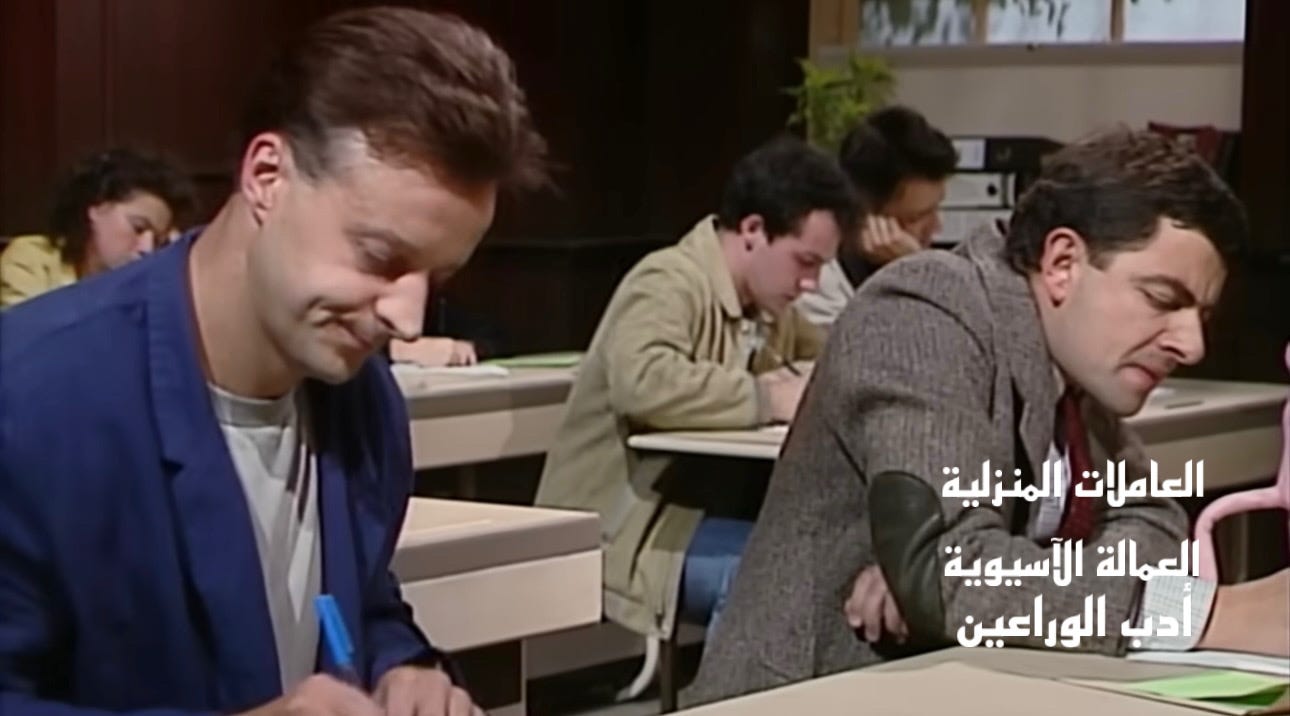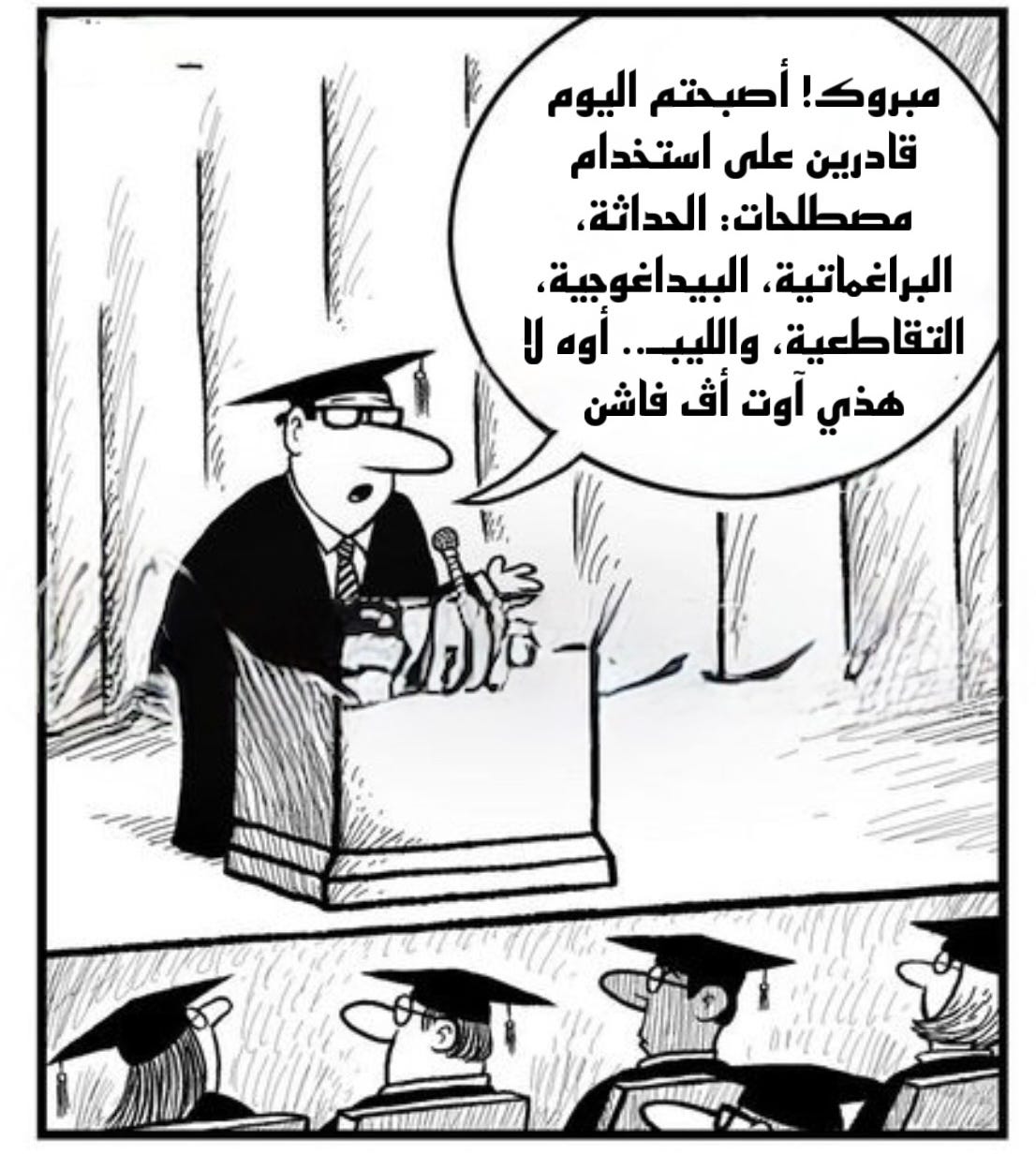أكاديميّو الفَلَس
لا أستطيع أن أحصي عدد المرات التي خضت فيها هذا النقاش مع الأصدقاء، ودائمًا ما يأخذ الموضوع ذاته عناوين ومحاور مختلفة، نناقش مرةً مشروعية استيراد الأفكار وتبيئتها عوض الانطلاق من نقطة مرجعية محلية أخرى، وكيف أن ذلك كفيل باختصار الوقت للوصول إلى الحلول، ومرةً يأتي الموضوع تحت عالمية القيم الذي تسمح باستقطاب الموضوعات وتلقي الأدب عمومًا، ومرات كثيرة يأتي الموضوع متخفيًا تحت عنوان عريض فحواه "الفكرة لا تأخذ مشروعيتها إلا عندما تأتي من مصدر نرى أنفسنا أقزامًا أمامه"، أما الكرزة التي تأتي فوق ذلك كله هو قول أحدهم: بس هذي حقيقة.
أود أن أورد هذا السيناريو لأجعل فكرتي واضحة.
في إحدى صباحات تشرين الخريفية، وأنت تحتسي قهوتك الأثيرة على أنغام رياض كريم وهي يقول "ماقول محبوبي نساني.. عنّك فلا تغير حناني.."، يأتيك طيف فكرة، تعبر ظلّت الذكرى، ولتنسى أحزانك بعد مقطع "دلّاك ع الفرقة زماني.." التي يأتي بعد كورال تشعر أنه قادم من مقبرة، تقرر أن تتصفح تويتر – المعروف لاحقا بـ "إكس" – وبعد عدة دقائق من التصفح، تلاحظ أمرًا ما.
تلاحظ عدة حسابات تعود لسيدات سعوديات، ولنقل أنها حسابات حقيقية لنساء حقيقيات كي نحيّد أي عامل آخر لا يخدم فكرة المقالة. تقرأ في إحدى التغريدات انزعاج سيدة وعدم ارتياحها عند خروجها إلى أحد المقاهي، إذ تشعر أن الرجال لا يتعاملون بشكل جيد في الفضاء العام، سوالفهم المخيسة تقتحم الطاولات الأخرى، قهقهاتهم عالية، وكأنهم يتسيدون المكان، أما النساء فلا يستطعن فعل الشيء ذاته، وبالتالي تشعر بأن الفضاء العام يقصي المرأة في حين يتحرك فيه الرجل بأريحية تامة كما لو كان ملكه.
ثم قرأت بعد ذلك ثلاثين أو أربعين تغريدة لسيدات أخريات تتناول موضوعات وقصص مشابهة دون أن يكون هناك علاقة بين هؤلاء النساء، جميعهن يسردن قصصًا تتعلق بعلاقتهن بالفضاء العام، إحداهن تتحدث حول قيادتها للسيارة ووجودها كأنثى تقود مركبتها في الشوارع العامة، وأخرى تتحدث حول وجودها في قاعات الانتظار في المستشفيات مثلًا، أو عندما تقف في طابور خلف إحدى أجهزة الصرف الآلي، وهكذا.
تريد بعد ذلك – وأنت المحنك – أن تتناول هذا الموضوع، لم لا وأنت حامل لعديد الشهادات من جامعات زوير وعوير، وهذه فرصة تغازلك لوضع حشود الأفكار البايتة في عقلك ضمن شوربة مصطلحات تربط ولا تحل، تُعقّد ولا تبسّط، ولا تثري سوى صورتك الاجتماعية أمام الدِّبش.
"النسويات السعوديات ومشكلة الفضاء العام"
عنوان جاذب جدا لأنه لن يكون ناشزًا بجانب العناوين الأخرى التي تتسم بالأكاديمية. وبالتالي، تكون عتبة ممتازة تخبر القارئ عن جدية الطرح في المقالة البحثية. بيد أن أول كلمة في هذا البحث وهذا العنوان هو الإشكال كله، وهو ما يأخذ الموضوع إلى منحدرات متشعبة لا ينتج عنها أي قيمة معرفية.
الثّنْغَنَة (من الـ thing وليس الـ thong)
لمَ قرر هذا المحنك أن ينعت ما رآه في إكس بالنسويات؟ الإجابة بكل بساطة هي: because it’s a thing، أي أنه شيء اكتسب شعبية أو شهرة في سياق ما وصار معروفًا في وسط ما - تحديدًا الأكاديميا - وهذه الشعبية كفيلة بإضفاء شرعية لهذه الفكرة. والأمثلة كثيرة على ذلك، تمامًا مثل عندما ترى صديقك يضع الكاتشب مع البيض، أو الأناناس مع البيتزا، ويقول لك: ترى عادي.. يسووها، it is a thing. أو عندما يرى أحدهم لأول مرة رجل كبير في السن، يرتدي ثوب وحذاء رياضي ويمارس المشي في المول، قد تستنكر، لكن عندما تكتشف أنه أصبح a thing يكون الأمر مقبولًا لأنه أصبح عرفًا الآن.
أعترف أني من أجل شرح هذه الفكرة كنت محتاجًا إلى بعض المصطلحات العربية لأن الفكرة أوضح في ذهني باللغة الإنجليزية، ولكني خفت أن أرى نظريات حول موضوع الثنغنة فأكتشف أنها is actually a thing وأكون قد وقعت في المحظور.
أتفهم أن يقع الناس في مداولاتهم اليومية في استخدام الثنغنة بوصفها وسيلة برهانية في شتى موضوعات الحياة، وخاصة في الديوانيات والأحاديث العابرة، لكن يكون الموضوع مربكًا إن قام بذلك باحث يُتوقع منه الكفاءة العلمية والأكاديمية على تفكيك المفاهيم وإعادة بنائها في أطر جديدة تتناسب وموضوع بحثه في سبيل إيضاح فكرة ونقدها أو تفنيدها.
ما يقوم به هذا الباحث المستحنك هو إنتاج معرفة غير أصيلة، تقوم أبحاثه على الشكل التالي: البحث أو الالتفات إلى ظاهرة ثقافية ما سواء في المجتمع أو الأدب أو السينما أو أي مجال ثقافي آخر، ومن ثم البحث عن نظرية موجودة في المدونات الأكاديمية بإمكانه استخدامها لتفسير هذه الظاهرة، وعليه يكون بحثه عظيمًا لأنه استطاع توظيف النظرية في مثال عملي حقيقي.
قد تبدو المعادلة السابقة للكثير معادلة سليمة ولا غبار عليها، بل محرزة أكاديميًا، إلا أنها للأسف ليست سوى خليطٌ ممجوج من خثاريق بعض الأكاديميين المفلسين. أتذكر ذلك الباحث الذي حصل على شهادة الدكتوراة في موضوع يتعلق بأدب السجون، وكان يحكي الصعوبات التي عاناها وهو يبحث عن نظرية يستند عليها، ولم يجد "المسكين" سوى نظريات ميشيل فوكو – أو بالأصح تطبيقاته – في موضوع السجون في كتابه المراقبة والمعاقبة / ولادة السجن.
أتعجب كيف لا يعي هذا الباحث الذي يحمل شهادة الدكتوراة، وهي ورقة تشهد بأن هذا الكائن قادر على البحث العلمي دون إشراف، بشكل مستقل، ولكنه في الوقت نفسه لا يعي أبسط أدوات البحث. لا يرى هذا الباحث في نفسه القدرة على مجابهة المنتجات المعرفية الأكاديمية الند بالند، هو خاضع لها، ولا يمتلك القدرة العلمية على صك مفاهيم جديدة بوصفه هو الشرعية المعرفية القادرة على إنتاج المعرفة، ولذلك هو في حالة بحث دائم ولا منتهي إلى أسماء تكون Authority figures، وأفكار سابقة في مدونات قبلية تشرعن رأيه، لأنها ثنْغَنَت أفكارها، بينما ما يأتي به هو أمر لا يعتد به.. طيب غناتي والدكتوراة حقتك؟
لا أعلم من أين يجب أن نبدأ في حل هذه المشكلة التي تبدو نفسية، وتحمل احتقار ذاتي كبير، الاحتقار الذي يؤدي بصاحبه إلى الاحتياج إلى فرد من منظومة ثقافية بعيدة جدا وتمتد لمئات السنوات للخلف في خط لا يتقاطع مع تاريخه، ليخبره من هو، ويشرعن ما ينبغي أن تكون عليه أفكاره وقيمه ومعتقداته، ولا يطمئن لفكرة إلا أذا أتت من عنده. وهذا يقودني إلى الإشكال الثاني لدى هذا الباحث.
عودًا إلى مثال النسويات، يعتقد هذا الباحث أن سبيله في فهم خزنة ومزنة وفتحية ورباب وزينب وحوراء وصيتة، واللاتي يعشن معه في ذات المجتمع، جيرانه، وعوائلهم تعود إلى قرون سابقة مع بعضها البعض، سبيله في فهمهن يكمن في العودة إلى تاريخ طويل ومعقد جدًا ينتمي إلى منطقة جغرافية وثقافية بعيدة، يعتقد أن الإجابة في فهم نساء مجتمعه يكون عند بيل هوكس وجوديث بتلر وأنجليلا ديفس وسيمون دو بوفوار. يود أن يأخذ تحويلة معرفية طويلة جدًا تتطلب منه قراءات لا تنتهي في أفكار وتاريخ أفكار وسياقات ثقافية متعددة، والكثير من التعميمات والتمطيطات، وإقحام آراء على مواقف، والكثير من الافتعال والتزييف، وبالتالي يقدم منتجًا معرفيًا مشوهًا، غير أصيل، وغير صادق، ولا يخدم أي أحد. لماذا؟ لأن النسوية is a thing، ومن السهل استخدامها ووسم مقالته بالبحث العلمي.
في حين يقوم الباحث الذي يعي ما يفعل بكتابة بحثه عبر شرح الحالة تمامًا كما هي، دون الحاجة حتى إلى استخدام مصطلحات ومفاهيم إلا إن كان مضطرًّا، لا يحتاج الباحث لمصطلح النسوية في مثالنا السابق أساسًا! يكفيه أن يذكر في معرض بحثه أن هناك حسابات لسعوديات (ويذكر كل ما يعرف من معلومات حولهن لأنهم بمثابة إحصاءات هنا أو Data)، ويبدأ بعد ذلك في تحليل وفهم الظاهرة من خلال البيئة ذاتها، أن يتواصل مباشرة مع هؤلاء النسوة، وطرح النقاط النقاشية والحجج التي تقدمها بشكل مباشر. هل يتعلق الأمر بالاستقلال المالي؟ هل للأمر جذور دينية؟ هل يختلف الأمر بين المدن الكبيرة والصغيرة والقرى؟ هل وهل.. وغيرها من الأسئلة التي تنبع من سياق الظاهرة ذاتها.
هذا العرض المعرفي أصيل وأكثر صدقًا، ويجعل التسلسل البحثي لديك منطقي وعضوي، ينقلك من سؤال إلى آخر لترى ترابط المفاهيم الثقافية وتعاضدها في خلق تلك الظاهرة، وبالتالي يكون البحث مثري على مستوى العرض وجمع البيانات وتحليلها ومن ثم تقديم التفسيرات والقراءات بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معها.
نعلم بأن مثل هذه الأبحاث أصعب عندنا من أماكن أخرى لعدم وجود الإحصاءات والبيانات، وأحد أسباب غيابها هو عدم قيام الباحثين بعملهم. نعلم أن من الصعب البدء في أبحاث دون وجود مصادر سابقة حول الموضوع ذاته، ولكن هذا لا يبرر عملية الاستناد على منتجات الآخر الغربية في فهم أنفسنا. أصبح دور الباحث السعودي مقتصرًا على نقل العلوم أو ترجمتها، ينتظر الآخر أن يقدم قراءاته ونظرياته الأصيلة لتصبح مشروعة معرفيًا ومن ثم يستخدمها، وهذا يبرر الحضور الباهت والمخجل للباحثين في الإنسانيات والأدب والدراسات الثقافية في المناسبات والفعاليات والمؤتمرات الخارجية، لأنهم يذهبون بوصفهم تلاميذ، أقزام، يقدمون أوراقهم على أمل أن يتم الاعتراف بهم والرضا عليهم، في حين نرى الباحثين من مناطق أخرى من الجنوب العالمي يحضرون بوصفهم مقارعين معرفيًا، نظراء، يكسرون الهيمنة المعرفية المكرَّسة كما ينبغي، ينقدوها بأدواتهم ليكون لهم صوت في الإنتاج المعرفي المعتبر.
الأمثلة أكثر من أن تحصى في هذا الجانب. هناك من يصف شخص آخر بالـ"حداثي"، وكل ما يقصده هو أن ذلك الشخص حليق الذقن والشارب، أو يكتب قصيدة النثر، وهو قادر أن يذكر هذه الصفات بشكل مباشر وواضح يرفع اللبس ويوصل فكرته بشكل أوضح، إلا أن هؤلاء "الباحثين" ينشطون في الضبابية والإبهام، وشوربة المصطلحات هذه توفر لهم ما يريدون. والأسوأ من كل ذلك، هو وقوفهم عائق لكل من يرغب في تقديم بحث أصيل وصادق لأنهم يسقّطون كل النشاطات التي لا تخضع لممارساتهم اللا أكاديمية. وبالتالي يكون النتاج الوحيد المقبول هو الأبحاث المشوهة التي لا تنتمي لشيء إلا لسلة المهملات.